الكاتب هشام مصطفى: الهوية الثقافية هي مجموعة القيم والروافد المعبرة عن شبكة العلاقات
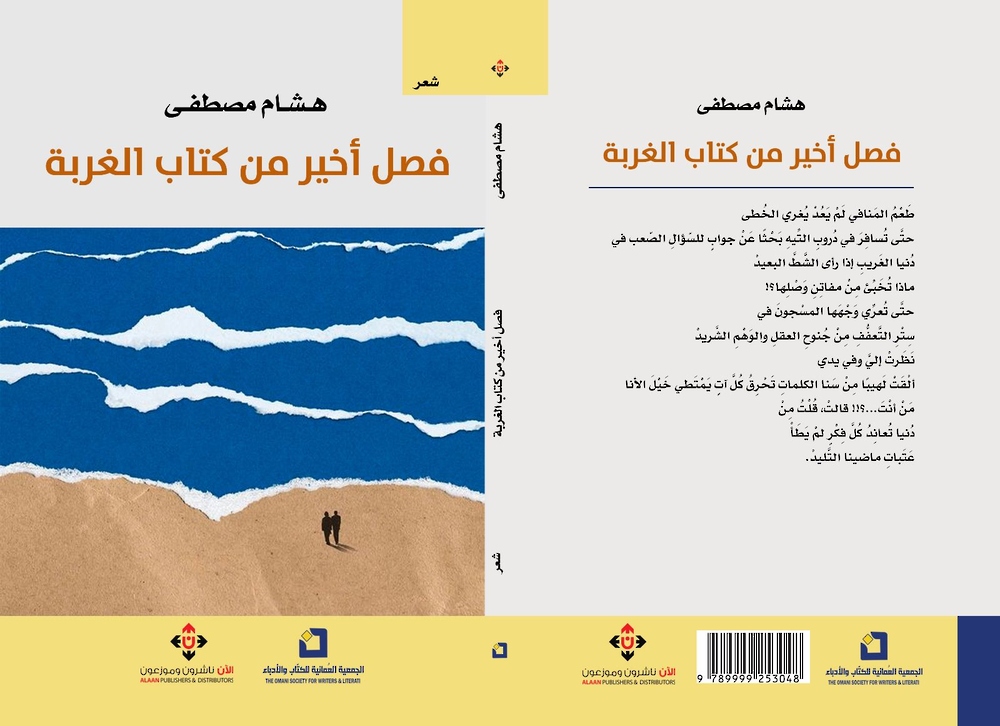
مسقط في 30 سبتمبر /إشراق/ يرى الكاتب والشاعر المصري هاشم مصطفى، الذي كان ولا يزال قريبًا من المشهد الثقافي في سلطنة عُمان من خلال أعماله الشعرية والنقدية، أن الهوية الثقافية هي في أبسط تعبير لها، مجموعة القيم من الروافد المختلفة والارتباط والتعبير عن شبكة العلاقات في إطار الفهم الحضاري للوجود.

ويضيف “مصطفى” الذي صدر له عدة مؤلفات من بينها “فصل أخير من كتاب الغربة”، عن الجمعية العُمانية للكُتّاب والأدباء و “سعيد الصقلاوي شاعر بحجم الألم”، “وفي أروقة الحداثة ـ بين متاهات الفهم ومحاولات الوصول” و “في حضرة العشق”، أن هذه القيم هي التي تشكل الوجدان والعقل الجمعي لمجتمع ما.
وفي سياق حديثه عن الهوية الثقافية وأسس تكونها في القصيدة العُمانية الفصيحة والشعبية، يقول هاشم مصطفى، في حديثه لوكالة الأنباء العُمانية: إن الأدب عمومًا والشعر خصوصًا مازال المعبر الرسمي والتقليدي لهذا الجانب، وأكثر ما يُخاف منه أن ينزلق الأدب والشعر بعيدًا عن تشكيل هويته وهذا يصعب على الفن الشعري لأن الشاعر في حالة تجادلية دائمًا بين المفاهيم والتقاليد والقيم والقصيدة العربية بشقيها الفصيح والشعبي، يعكس التمسك العُماني بكل ما يتعلق بهويته، بل تجد من المدهش أن الرقيب الحقيقي والواضع لحدود التمرد في النص الأدبي العُماني، الهوية والانتماء، فلا تجد التمرد في النص العُماني ظاهرًا بتوحش بل بعقلنته، بحيث لا يتعدى الحدود المجتمعية، فالتاريخ والدين والقيم والعادات والتقاليد ظاهرة بوضوح كبير في النصوص حتى المتمرد منها على مجتمعه.
ويضيف أن النص الشعري العُماني عادة ما يعبر عن خصوصية الهوية الثقافية، وعن مجتمعه.
وخير شاهد على ذلك المقطع الشعري لسيف الرحبي الذي يظهر فيه التمسك بروح مطرح ورفض التطوير المقيت للحداثة التي يخشى الشاعر توغلها بهذا التعبير الراقي (الدنيا ذهبت بنا بعيدًا وأنتِ ما زلتِ تتسلقين أسواركِ القديمة)، كما يظهر في نصوص الشاعر المهندس سعيد الصقلاوي تمسّكه بملامح التاريخ البحري تارة فيذكر مفرداته ويشدد عليها والاعتزاز والاحتفاء معًا بالقرى والمدن العُمانية، ويبدو الوطن معادلا موضوعيا للإنسان في مختلف النصوص الشعرية بتعدّد مشاربها واختلاف توجهاتها. فنستطيع القول باطمئنان أن النص العُماني يعبر تعبيرًا دقيقًا عن هويته الثقافية ويعتز بها أيما اعتزاز ويتمسك بها تمسكه بوطنه.
وحول رؤيته لواقع الأدب العُماني في المجمل حديثًا وقديمًا يقول الكاتب هشام مصطفى: إذا أردنا أن نقف أمام المشهد الأدبي والشعري الآني في عُمان فلا يجب أن نغفل جذوره الممتدة في تاريخ الأدب العربي؛ فعُمان جزء أصيل من هذا المشهد، إلا أنه يمكن وصفه بالمشهد الغائب الحاضر الذي لا يعرف مبرّرًا لغيابه رغم الحضور الطاغي سواء كان على مستوى النثر والخطابة أم على مستوى الشعر وبالتالي النقد، فثمة إخفاء تسبب في غياب السردية التاريخية الأدبية من تاريخ الأدب العربي؛ بحيث يجد أي دارس لهذا الأدب في تحصيل المصادر صعوبات جمة؛ لتكوين رؤية أعمق له، ومثال ذلك الذي لا تخطئه العين أن تغيب حقيقة المقامات حيث إن الواقع والتحليل العلمي الرصين يخرج بنتيجة حاسمة؛ أنها بدأت من عُمان وانتهت فيها، وقد تكون هذه الحقيقة صادمة للمبدع العُماني ذاته، إلا أنه في دراسة ( لهدى حمد) نشرت في مجلة نزوى بعنوان الفكر في عُمان بين التاريخ والتأريخ، ركزت على هذه الحقيقة، وهذا غيَّر الكثير من آراء النقاد العرب قديمًا إلا أن ذلك لم يشفع لكتاب تاريخ الأدب أن يتناولوا هذا الأدب بالدراسة والتحليل إلا في بعض النواحي وعلى مستوى التجارب الفردية سواء للناقد أو للشاعر محل الدراسة، وهذه تحديدًا كانت عائقًا كبيرًا لبيان قيمة وحجم المنتوج الأدبي العماني.
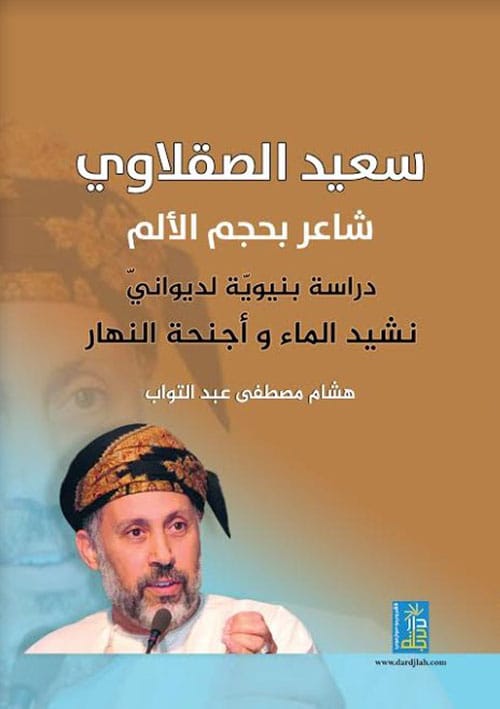
وعليه فالولوج إلى ذلك البحر الهائل والإنتاج الغزير جعله بعيدًا عن الإضافة الحقيقية له لمجمل تاريخ الأدب العربي، وهو ينتظر بالفعل أن يجد من يكشف النقاب عن حجمه وأثره؛ فالأدب العُماني قديمًا وحديثًا أدب بكر ويجب اكتشافه ووضعه في مكانته فهذا ما يجب على كل المثقفين فعله بمجموعات بحثية، سواء أكانت أكاديمية أم فردية مجتمعية، وإن ظهرت بواكيره في مجال التاريخ؛ فإننا ننتظر أن يقفز إلى الأدب أيضًا.
وحول روح القصيدة العُمانية وماهيتها ووجودها وتوجهاتها يقول الكاتب “مصطفى”: الاقتراب من فهم عميق لمصطلح روح القصيدة في العموم وبالطبع ينسحب على المقصود مما يتم طرحه من روح القصيدة العُمانية المحفوفة بالمغامرة؛ حيث النتائج غير حاسمة، لهذا فإن علينا أولًا فهم مصطلح الروح، فأفلاطون يرى أن الروح أساس لكينونة الإنسان والمحرك الأساسي له، في حين قام أرسطو بتعريف الروح باعتبارها محورًا رئيسًا للوجود، ولكنه لم يعد الروح وجودًا مستقلًا عن الجسد، أو شيئًا غير ملموس يسكن الجسد.
ويشير إلى أن أرسطو قد غاير أفلاطون معتبرًا الروح مرادفًا للكينونة، ولم يعُد الروح كينونة خاصة تسكن الجسد، أما الإمام حامد الغزالي في كتابه الإحياء فيعُد الروح جسمًا لطيفًا منبعه تجويف القلب الجسماني، ينشر من خلال العروق أثره وهو فيضان أنوار الحياة على الجسد، مثله مثل فيضان النور من السراج داخل البيت وأرجائه، لهذا فمصطلح الروح يعني أساس الشيء ووجوده وتأثيره في الوجود من حوله وهكذا يمكن أن نفهم تعدد الفهم لروح القصيدة، فهل هي المفردة، أو هل هي “أستطيقا” النص أي (الإدراك الحسي)، أم هي البنية المجازية للنص، على أننا يمكن أن نعُد كما أسلفنا روح القصيدة هو الذي يجعل النص فنًّا مع تعدد روافده، وهنا يكمن غناء روح النص أو القصيدة العُمانية، فثمة تاريخ ضارب في القدم، وثمة حداثة هادئة تتغلغل في كيان القصيدة تنتج جدلية غير مرئية قوية ما يجعل الإبداع العُماني له خصوصية حتى في قصيدة النثر، بدا ذلك جليًّا وهل هناك أروع من تلك الصورة المدهشة لسيف الرحبي حينما يقول: (مطرح الأعياد القزحية البسيطة والأمنيات المخمرة في الجرار، الدنيا ذهبت بنا بعيدًا وأنتِ مازلتِ تتسلقين أسواركِ القديمة)، فالمفردة ليست بمنأى عن سلطة المكان والمجتمع، والرمز في معظم الأحيان مستقى من البيئة والقيم العُمانية.
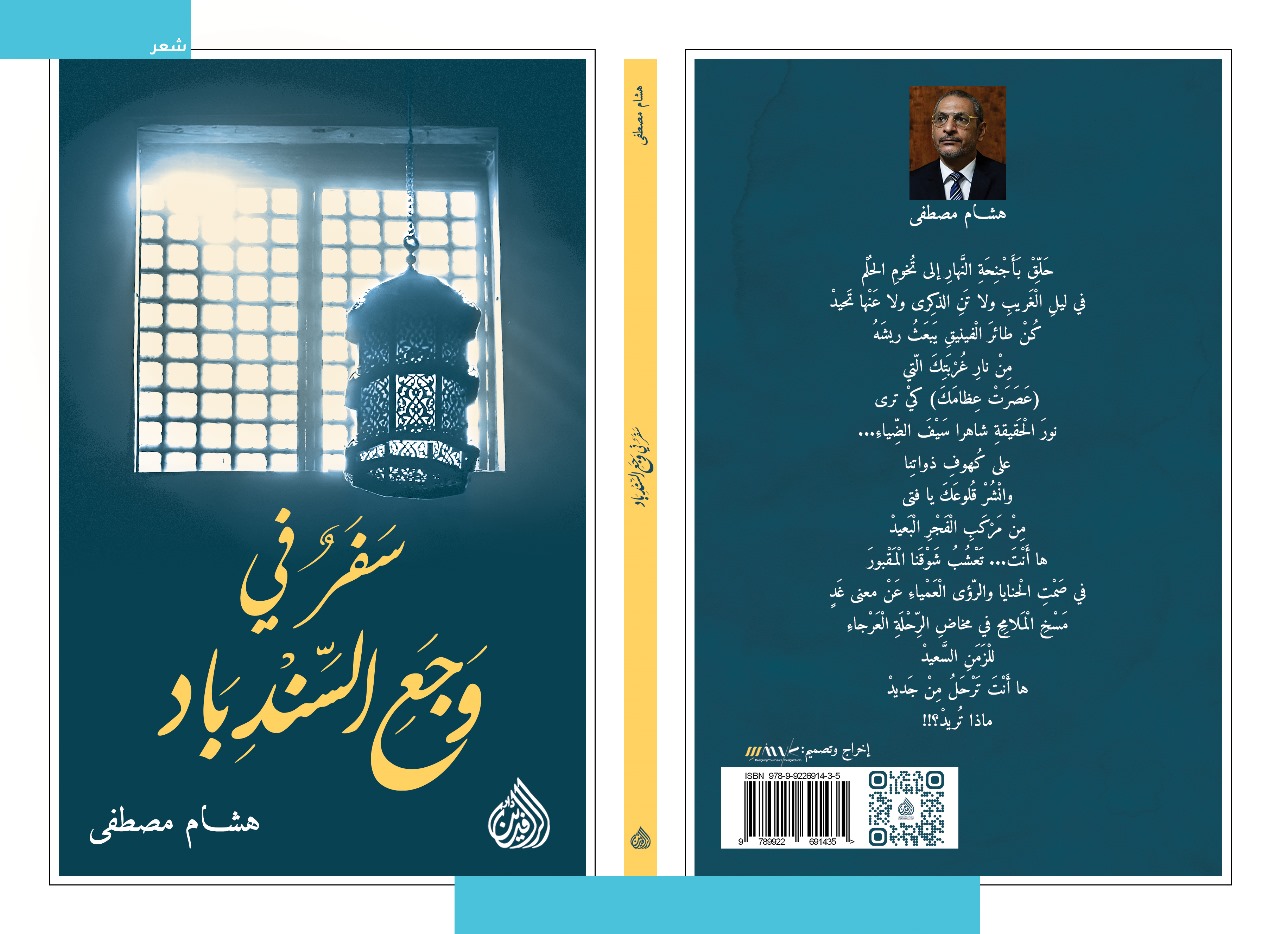
ويشير إلى أن ثمة تطويعًا للمفردات والتخييل النابعة من سلطة المكان والمجتمع على المبدع والنص معًا مقارنة بباقي الأدب في الوطن العربي، فمعظمه استطاع أن يتفلّت من المجتمع بل يصبح متمردًا عليه إلا في عُمان فمازال المجتمع له هيمنته على معظم المبدعين والنصوص، وهنا يكمن الفرق والمغايرة لهذا الأدب وبالتالي فروح القصيدة العُمانية يمكن أن تلحظها من تعدّد روافدها ما يجعلها متفردة عن الأخريات بوضوح على كافة الأصعدة.
وفي حديثه عن النقد في سلطنة عُمان ما له وما عليه يقول “الكاتب مصطفى” أن أي باحث مطّلع على مسيرة النقد في سلطنة عُمان إدراك المأزق الذي يعانيه، ولكن بابتعادنا خطوة للخلف يمكننا أن نرى المشهد الكلي لهذا الواقع، علينا أولًا أن نقر بأن هذا المأزق لا يخص النقد في عُمان دون غيرها؛ فتراجع الأعمال النقدية مقابل الإنتاج الغزير للإبداع ليس مشكلة في عُمان فحسب بل مشكلة عالمية، وعليه يجب أن نأخذ الأمر ليس بالتحامل على الساحة النقدية في سلطنة عُمان بداية، إلّا أن ثمة إشكالات نابعة من النقد ذاته يضاف إلى الحقيقة السابقة، فما المقصود من النقد؟ هل هو النظرة التقليدية له بصفتها سلطة مهيمنة عليه وضابطة تعنى بالحكم لا القراءة وذلك بتعدد مناهجها الانطباعية أو النقد التاريخي أو النفسي أم النقد الذي يقوم على كشف النقاب عن البناء وجدليته، فوسط هذا يغيب عن ذهن المبدع أن النقد في حقيقته الآن هو النص الموازي والإبداع الثاني لنصه، ولكن بصورة أكثر تأسيسًا لهذا الإبداع الثاني والنص الموازي فليس المبدع مطالبًا بتأسيس رؤيته أو أيديولوجيته أو معتقده، بل يظهر ذلك من خلال بنية النص أو الفن عمومًا لكن مع النقد فالأمر مختلف تمامًا والعملية الإبداعية بتعدد أوجهها لا تستغرق وقتًا مثلما يستغرقه النقد لذات العمل.
ويؤكد على أنه من جهة أخرى إن تجاوزنا مفهوم النقد علينا أن نعرف جيدًا أن ثمة فرقًا بين النقد الأكاديمي الذي يسكن ساحات الجامعات وأروقتها وبين النقد التطبيقي الذي يتولاه فريق من النقاد وليس بالضرورة أن يكون منتسبًا لجامعة أو كلية ما، فالأول معني بالمنهج وإجراءاته أكثر من النتائج لهذه الإجراءات لذا تجد أن متابعة مثل هذه النوعيات لا تكون إلا لمتخصص أو للنقد التطبيقي، فهؤلاء هم جمهوره ومستهدفه، أما الناقد التطبيقي فالمستهدف لديه هو القارئ بتعدد مستوياته الثقافية، لذا فاللغة هنا غير اللغة هناك والتوظيف هنا غير التوظيف هناك بل يمكن أن نتجاوز ذلك بأن نقول أن المنهج لدى الأكاديمي هو المستهدف والغاية غير مراعٍ لمتلقيه، في حين أن المنهج لدى التطبيقي هو جسر للوصول قد يأخذ منه البعض ويترك البعض سعيًا لكشف ما في النص الأدبي أيًّا كان انتماؤه أو بنيته.
ويوضح أنه من جهة ثالثة يأتي السؤال الملح هل كل أكاديمي في النقد ناقد يمكن أن يخاطب الجمهور بتعدد مستويات ثقافته؟ بالطبع لا، فالأكاديمي مارس إجراءات المنهج النقدي من خلال أطروحته لنبيل درجة علمية تبيح له ممارسة تدريس النقد وهناك فرق واضح وجلي بين تدريس النقد وممارسة النقد فلا يجب أن نقول أن هناك جيشًا من النقاد والقليل من النقد لأننا يقينًا نظلم النقد والأكاديمي معًا، ومن جهة رابعة العملية النقدية عملية شاقة في الواقع تحتاج إلى الوقت الكافي لإنتاج عمل نقدي تطبيقي قد تصل إلى ثلاث سنوات من الجهد المتواصل، فشاعر بحجم ألم الدراسة البنيوية التفكيكية لشعر الشاعر الكبير سعيد الصقلاوي استغرقت قرابة الثلاث سنوات، وكذلك في أروقة الحداثة مع النماذج التطبيقية للشاعرة الدكتورة سعيدة بنت خاطر الفارسية والدراسة المقارنة في الصورة بين سعيد الصقلاوي والشاعر هلال العامري مع حفظ الألقاب لهما بمكانتهما الكبيرة في المشهد الأدبي العُماني استغرق كل هذا قرابة السنتين ونصف مع العمل المستمر.
ويضيف أيضًا أنه حاليًّا يُعدُّ كتابًا نقديًّا عن الشاعر يحيى السماوي فالفصل الأول التأسيسي استغرق قرابة العام فلا يجب أبدًا خلط الأوراق بين المقال النقدي أو البحث المصغر في قصيدة قد تكون انطباعية تحمل رؤية شخصية أنها نقد، فالنقد عمل شاق يجب أن يؤسس له ومن ثم يمارس المنهج والتركيز على النتائج ولهذا لا يجب أن نجلد الذات باتهام النقاد أو العملية النقدية بالتراجع أو التراخي أو الغياب دون البحث وراء العلل.
فهل تساءل أحد عمّا يجب على المجتمع بمؤسساته المدنية من دعم للناقد حتى يمكن له أن يقدم عملًا معتبرًا جديرًا بالطباعة، فلا نقول الدعم مثل التيار الاشتراكي وهو الأيديولوجية بل الدعم في الطباعة والترويج، نعم هناك مؤسسات مثل الجمعية العُمانية للكُتّاب والأدباء أو مجلة نزوى، ولكن هل طاقتهما تكفي لتغطية كامل العملية النقدية ومحفزة لها وهل لهما من الطاقة للترويج ليصل إلى المستهدف وهو القارئ؟ هناك مشاكل كثيرة تواجه النقد في عُمان وبالفعل ينطبق عليهما قوله تعالى (اذهب أنت وربك فقاتلا) فيجب أن تتضافر الجهود، وكذلك يأتي السؤال المهم أين دور المراكز البحثية النقدية في الجامعات من هؤلاء النقاد التطبيقيين أو مختبرات اللغة والنقد والسرديات؟ هناك من العمل الكثير الذي يجب القيام به ومن ثم يمكن لنا أن نقيم العملية النقدية في عُمان.
وعن التماس ما بين قصيدة الشعر الفصيح والقصيدة الشعبية وملامح التقاطع معها يقول “مصطفى” إن القصيدة في أبسط تعريفها ضرب الأدب وقوامها البنيوي من الوزن الخليلي أو التفعيلة، وتعتمد على لغة المجاز غير أن تواجد قصيدة النثر غير من المعادلة وجعل اللغة المجازية هي العمود الفقري لأن تحسب العمل الفني قصيدة أو تخرج عنها للسرديات.
ويضيف: “القصيدة واحدة سواء أكانت باللغة الفصيحة أو بالمفردة العامية الشعبية لأن البنية واحدة والوزن متقارب وإن شئت تحديدا فالموسيقى متواجدة ما يعني أن ثمة تطابقًا بين النوعين يكاد يكون تاما إلا في المفردة الملتقطة وقد يكون الخلط ناتجا عن فكرة أن العرب قديما كانوا يتحدثون الفصيح فقط وعليه تكون الشعبية دخيلة أو لأنها باللغة المحكية أو لغة الأسواق تسقط شرعيتها، فالفرق بين القصيدة الفصيحة والأخرى الشعبية هو الالتزام بالضبط للغة لا أكثر ولا أقل.
ويشير إلى أن لغة القصيدة الشعبية هي لغة ملحونة في رأي اللغويين قديما وكانت تطلق عليها لغة الأسواق، والدليل هو الكم الهائل من التراث المحكي الشعبي الذي بدأ توثيقه أخيرا ، وحسب الدكتور عبد العالي ودغيري، صاحب قاموس “العربيات المغتربات” فإن عددا من اللهجات العربية القديمة، سواء ما أدمج في الفصحى المشتركة المختارة من لهجات العرب، أو التي لم تدمج، ظلّت “قائمة ومستعملة على هامش الفُصحى” ولأن القصيدة الفصيحة وجدت شرعيتها من الاعتراف بها خلال ما قام به النقاد قديما وحديثا للتأسيس لها وتتبع تطورها، ولم تجد القصيدة الشعبية نفس الاهتمام، بل على العكس وجدت الإهمال على اعتبارها قصيدة العامة والأخرى قصيدة (عكس العامة)، وبناء عليه فقد تكون القصيدة الشعبية في فترات كثيرة هي الأكثر تعبيرا عن آمال المجتمع وآلامه وتعبيرا عن الإنسان البسيط وأحلامه البسيطة حيث درس عددًا من القصائد الشعبية محاولا التأسيس لها من خلال القراءات المعمقة بالمناهج النقدية الحديثة خلال نشر هذه الدراسات في ملحق مجلس الشعر الشعبي الذي تولى إخراجه الشاعر مسعود الحمداني لهذا فما ينقص القصيدة الشعبية التأسيس لها وأعتقد بأن هذا الاتجاه بدأ في الآونة الأخيرة.
جدير بالذكر أن القصيدة الشعبية أخذت منحى الحداثة فهمًا واستخدامًا ولغة وإن حافظت على الإيقاع والموسيقى وأعتقد بأن الشاعر محفوظ الفارسي يقوم بهذه التجارب الشعرية الإبداعية الجديدة وألحظ من خلال قربي للمجتمع الإبداعي الشعبي أن شعراءه أكثر نشاطا في تجميع أنفسهم وتكوين البرزات والمجالس الخاصة بهم وبروزهم من خلال مؤسسات المجتمع المدني والأهلي مثل النوادي، وإتاحة الفرصة لأصواتهم للوصول إلى ساحة أكثر اتساعًا من الجمهور خاصة وأن الشعب العُماني محبّ للشعر ومتذوق له بل وناقد بالسليقة نقدا حدسيا عميقا يجعل أي مبدع حريصا ولا يغامر بالوقوف أمامه إلا متسلحا بنص يحترم هذه الذائقة ولهذا نجد لفرسان القصيدة الشعبية حضور بارز في الساحات الإقليمية بل وهناك من وصل إلى أهم المسابقات الشعرية.





